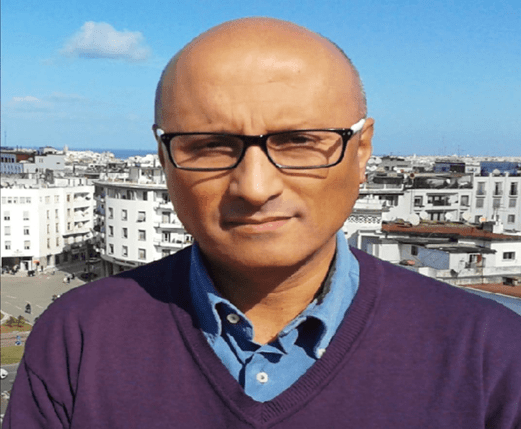العرائش نيوز:
عبد المنعم العمراني
بسبب خوفهم، المبرر والطبيعي، من الزوال، أي من الموت، يقبل الناس تسليم أمر نفوسهم إلى سلطة القانون التي تجسدها الدول والحكومات. هكذا تكلم الفيلسوف وفقيه القانون الإنجليزي ‘توماس هوبز’ منذ قرون. واليوم نرى كيف يقبل المواطنون، في مختلف المجتمعات، التخلي عن جزء كبير من حقوقهم الطبيعية في التنقل والحركة والتعبير مقابل الحفاظ على حياتهم. وهم بذلك ينصاعون إلى ما تمليه عليهم حكومات دولهم، دونما جدال كبير. يفعلون ذلك لأنهم خائفون على سلامتهم وسلامة ذويهم.
أما ما تقدمه قراءة فكر ‘توماس هوبز’ بخصوص هذا الخوف – في زمن كورونا – فيجمله الكاتب الفرنسي ‘ألان بوليكار’ بالقول: “إن ذلك الخوف، يتم التأسيس له من طرف أولئك الذين يمسكون بزمام الأمور”.
لكن الماسكين بزمام الأمور يخافون، هم الآخرون. يخافون من انهيار البناء المجتمعي، ومن سيادة الفوضى، ومن توقف عجلة الاقتصاد المذرة للربح. وقبل هذا وذاك، يخافون على خسارة الامتيازات التي يتمتعون بها لأنهم يمسكون بزمام الأمور. امتيازات وأرباح، يقول لنا فقهاء النظام الليبيرالي الجديد – المتحكم في دواليب صناعة القرارين الاقتصادي والسياسي منذ ثلاثين سنة ونيف – إنها تمكنهم من تدبير الأمور لضمان الحل الوحيد، الممكن، لمشاكل البطالة والفقر، في رأيهم. قبل أن يضيفوا أن هذا الحل سينعكس، لا محالة، بالخير العميم على كل شرائح المجتمع.
غير أن ما حدث غداة كل أزمة اقتصادية أو حرب ضروس أو جائحة فتاكة أو إعصار طبيعي، غالبا ما كان هو العكس: ربح كبير ملأ ويملأ جيوب أقلية بعينها، ومآسي نزوح داخلي وخارجي دفع – ويدفع – أغلبية بعددها نحو مزيد من اليأس والفاقة والفقر، الذي يصبح مميتا في أحيان كثيرة. أغلبية تكون لا زالت تئن تحت هول صدمة ما أصابها بسبب الأزمة أو المرض أو الإعصار، فلا تنتبه إلى من يكون قد بدأ في اغتنام الفرصة لوضع برامج جديدة – لا تختلف في جوهرها عن الخطط السابقة – من أجل إعادة تدوير عجلة الإنتاج، عبر نفس النسق الذي كان قد أدى بها إلى التعطل عن الدوران. فتستمر الصدمة ويستمر الخوف، الذي يغديه الماسكون بزمام الأمور، طمعا في حصد مزيد من الأرباح. إنها نظرية الصدمة كما فسرتها الناشطة الاجتماعية الكندية ‘نعومي كلاين’ في كتابها “عقيدة الصدمة – بروز رأسمالية الكارثة”.
في هذا الكتاب الذي صدر عام 2007، حيث كانت بوادر الأزمة المالية التي عصفت بمدخرات صغار الناس في بنوك كبارهم، قد بدأت تلوح في الأفق، تقسم ‘كلاين’ سياسة إدارة الأزمات في النظام الليبرالي الجديد إلى مرحلتين. في المرحلة الأولى تقوم الحكومات باتخاذ إجراءات استعجالية هدفها إدارة الأزمةوتدبير تطورات الكارثة.
فتحد مثلا من قيمة الأموال التي يمكن للمواطن أن يسحبها من حسابه المصرفي، كما حدث في اليونان عام 2010. أو تقيد حركة الناس وتقمع حريتهم في التعبير والتظاهر، كما جرى ويجري في زمن كورونا. ينصاع الناس لأنهم خائفون من الضياع والجوع والموت.
أما المرحلة الثانية، فتبدأ مع ما تسميه الطبقة الماسكة بزمام الأمور بالإصلاحات الضرورية لتخطي تبعات الأزمة أو مخلفات الكارثة. وهنا مكمن الخطر الذي تنبه إليه ‘نعومي كلاين’ عندما تقول إن تلك الإصلاحات غالبا ما يتم تطبيقها في غفلة من الغالبية التي تكون ما زالت واقعة تحت تأثير الصدمة وهول الكارثة التي حلت بها. ما يعطي للأقلية المتمكنة فرصة جديدة لتكديس الثروة قبل البدء في إعادة توزيع القليل منها، من خلال نفس النسق الذي يؤمن لها الاحتفاظ بالجزء الأكبر والأهم من الكعكة، بل وتنميته بشكل يخدم، حصريا، مصالحها الخاصة.
والخلاصة هي استمرار الاستغلال البشع للممتلكات العامة غداة انحسار الكارثة، أي عندما تكون ذهنية الغالبية لا زالت مركزة على مشاكلها الآنية في محاولة يائسة للحفاظ على بعض من مصالحها وشيء من كرامتها، وهي تحاول جاهدة التغلب على الشعور بالخوف. ذلك الشعور الذي تواصل أجهزة “الإعلام الجماهيري” الضرب على أوتاره الحساسة، رافعة شعار درء خطر الكارثة للحفاظ على حياة الناس.
وهنا المفارقة: الخوف ممن؟ والخوف على من؟ والخوف من ماذا؟ تلك المفارقة التي حاول الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت تفسيرها لمواطني بلده المرعوبين، وهو يتسلم مقاليد الحكم سنة 1933 غداة الأزمة الكبرى لعام 1929، عندما قال لهم: “إن الشيء الوحيد الذي علينا أن نخاف منه، هو الخوف نفسه”.